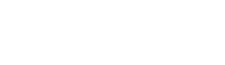قبل أن يسقط الرمز

تصوّرت وأنا أطأ تلك الأرض العربية.. للمرة الثانية. أنني تركت
أفكاري المضادة عند الجمارك. وكآلاف السواح سآخذ حمام شمس،
وأحتسي كثيراً من الشاي وأعود بحقائب مملوءة عباءات.
ولكنني وجدت نفسي كالمرة الأولى، عاجزة عن أن أكون مجرد سائحة.
خاصة وأنني في هذه المرة سأقضي أياماً في ضيافة العائلة المالكة.
أي مغامرة كانت أن أتخلى مرة واحدة عن كل ما أؤمن به.
أن أتناول غذائي وخلفي زنجيان بقفازات بيضاء يحرمانني حتى لذة تقطيع الخبز بيدي.
أن آخذ حمام شمس في شاطئ خاص، يراقبه ما يقارب الخمسة عشر
حارساً، وكأنني جاكلين في الجزيرة التي أهداها إيّاها زوجها الراحل
أوناسيس.
أن أستمع إلى أي أغنية أريدها بصوت المغني نفسه وبإبداع أو بتصنّع
أكثر.
كان عمري عشرين سنة، وكنت أرى وجودي في ذلك القصر محض
فضول طفولي.
كنت في أعماقي أحتقر كل الفنانين الذين التقيت بهم في تلك الظروف.
تناقشت بعدها مع أحدهم. كان يعتقد انه (ملتزم).
قال مبرراً وجوده هناك “ما رأيك بعبد الحليم؟ إنه في هذه اللحظة يغني
في القصر الآخر!”.
قلت “قد أغفر لعبد الحليم لأنه ليس من هذا البلد.. هو لا يغادر القصر
ليرى الشعب.. ثم أنه ملتزم أولاً برد جميل الملك! أما أنت فتعرف شعبك
أكثر منّا وتعرف ما يريد”.
كان هذا أول نقاش لي. سألني آخر بعدها.. ما الذي يزعجني في هذا
البلد الرائع؟ قلت “ربما أفكاري.. أنا لست ملكية!”.
أجاب بهدوء “لا تنزعجي كثيراً إذن.. فلكل بلاد ملكها. كلّ من لا يمكن
توجيه الإنتقاد إليه.. هو ملك”.
كان على صواب.. لكنني لم أستسلم.
قال أخيراً “هذه مشاكل ستحلّ بتحرير أرضنا”، قلت” بل بتحرير الإنسان
أولا”.
تذكرت فجأة عندما منذ عام، كنت أمرّ بمدينة في ذلك البلد المجاور، وإذ
بسيارة تتوقف، وجموح الفلاحين يسرعون نحوها ليلثموا يد رجل ينزل
منها ويمدّ يده نحوهم بكل برودة وتجاهل..
قبلها كنت أتحدث كثيراً عن الثورة.
يومها ما كان بإمكاني تغيير شيء في ذلك الموقف، فأفكاري لن تمنح
رغيفاً لفقير. ولا هي سترد الكرامة لرجل مهان. ما عاد يكفي أن نثور..
يجب أولاً أن نخلق الإنسان الذي يحمي الثورة.
قررت أخيراً أن أصمت.
ولكن بدأ صراع جديد عندما طالبني أحدهم في سهرة أن (أنشد) شعراً.
وسرعان ما أصبح الأمر مطلباً جماعياً يقتضيه السمر.
قلت جادة: “لا أكتب شعراً يليق بهذه المناسبات”
أحتجّ البعض مطالباً بأية قصيدة حب.
قلت أنني لم أكتب شعراً في الحب.
طالبوني بإرتجال قصيدة “عنهم”.. ضحكت.
آخر قصيدة كتبتها، كان موضوعها الجنود الذين ارسلوا إلى الحدود
لأسباب غير حربية.
لو قرأتها عليهم ماذا كان يمكن أن يحدث!
لا شيء ربما..
لن أموت ولن أسجن، فقط سيظنون أنني جننت لأنتقد حاكماً في قصره.
أخيراً قرأت عليهم قصيدة رمزية، فهمها كل واحد كما أراد.
أدركت يومها أن الرمزية خيانة لأنها جبن. أضفت إسمي إلى قائمة
المبدعين الذين أحتقرهم. وكان عليّ أن أرحل قبل أن ينكشف الرمز!
- Advertisement -