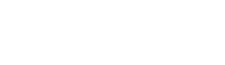الحوار الأخير في باريس لذكرى عز الدين قلق
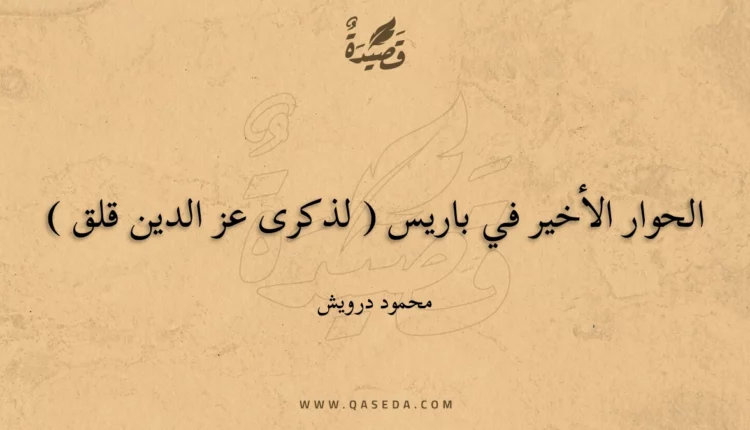
…..على بابِ غرفتهِ قالَ لي : إنهم يقتلونَ بلا سببٍ
هل تحبُّ النبيذَ الفرنسيَّ؟
والمرأة الشاردهْ
تطلَّعَ خلفَ الجهاتِ , وحاولَ أن يفتحَ البابَ
لكنّهُ خافَ أن يخرجوا من خزانتهِ
فرجعنا إلى المصعد….
الساعةُ الواحدهْ
وباريسُ نائمةٌ . من هنا يبدأ الليلُ
من أينَ ؟ من شارعٍ واسعٍ لا يسيرُ عليه سواكَ’
ومن شجرٍ لا تراهُ’
ومن جسدٍ أبيض يشتهيكَ’
ومن طلقةٍ قد تراكَ
أتقرأ كافكا وتدخلُ في الليل؟
كان زماناً جميلاً وكانتْ دمشقُ نهاياتِ أحلامنا
ذهبنا إلى بردى وسألناهُ:
هل أنت نهرٌ أم اُمرأةٌ زاهدهْ؟
فلم يخرجونا إلى النهر ثانيةً…
صاحِ ! هذي زنازيننُا تملأُ الأرضَ من عهدِ عادٍ’
فأين البياضُ وأينَ السوادُ؟
….وباريسُ نائمةٌ في الرسومِ على حافةِ السِّيْنِ
كُلُّ روايات باريسَ غَارقةٌ في التلوث
وحدهُمُ العاشقونَ يظنونَ أن المياهَ مرايا فينتحرونْ….
أين ننامُ أخيراً؟
على مقعدٍ في الحديقةِ
قلتُ : ألا يقتلون ’ ولكنه تَعَبٌ لا يخافُ
وقلت : أيوجعُكَ الليلُ؟
قال : وتوجعني الروحُ والنجمةُ الباردهْ
لعلَّ الفتى حجرٌ…
من بعيدٍ يرى مُدُنَ البرتقالِ السياحيِّ
والكاهن العسكريِّ
ولكنه يجمعُ الملصقات ويكتب فوق بقايا السجائر آراءهُ في الغزاةِ
الذين إذا شاهدوا مُدُناً هدموها بأسمائهم واستراحوا على العشبِ
قال : لماذا تكون الثقافةُ ظلّ الجنودِ على ساحلِ الأبيضِ المتوسط؟
قلتّ: وخادمةً للبلاطِ وللفئة الزائدهْ
…. قد اعترفوا أنهم قتلوني
ولكنهم عانقوني طويلاً
ودسّوا مكان الرصاصةِ عشرين ألف فرنكٍ مكافأةً للخطابِ الذي سوف أُقنعُ فيه اليسارَ الفرنسيَّ أن السجونَ على ضفةِ النهر مستشفياتٌ
وأنَّ دمي مائدهْ
وكان صديقي يطيرُ
ويلعب مثل الفراشة حول دمٍ
ظَّنهُ زهرةً ،
كان مستسلماً
للعيون التي حفظتْ ظلَّهُ ,
وكان يرى ما تراه العيونُ التي حَفظت ظلّهُ,
كان مزدحماً
بالأزقة والذاهبين إلى السجن والسينما
والليالي التي امتلأت بالليالي
وباللغة الفاسدهْ
وكان يودَّعني كلما جاءني ضاحكاً
ويراني وراء جنازتِهَ
فيطلّ تؤمن الآن أنهمُ يقتلون بلا سببٍ؟
قلتْ : مَنْ هُمْ؟
فقال : الذين إذا شاهدوا حُلُما
أعدّوا له القبرَ والزهرَ والشاهدهْ
… وكان يحبُّ وينسى
ويسألني دائماً : يا صديقي لماذا أُحبُّ وأنسى التي سأحبُّ ونبقى
غربين في مصعدٍ ينظران إلى الساعةِ الجامدهْ؟
يحبُّ وينسى
ويذكر شكل النباتات حول الدروب التي خرجتْ من شمال فلسطين في شهر مايو ولم ترجع
الأغنياتُ التي ودَّعتْ نازحا
والأغاني التي استقبلتْ فاتحا
تتشابهُ,
قالَ: أفكَّرتَ في الانتحار قليلاً؟
نعمْ
ألأنَّ الرفاقَ يخونون مثل الغدير
لأنَّ الرفاق يمرّون كالساقيهْ؟
قلتُ : كلا ! أينتحر المرء من أجل جُمّيزةٍ هامدهْ؟
قال : كلا
أأدركتَ أنَّا نمرُّ على الأرض ظلاّ
وجسمك ليس نحاساً ليحمل هذا الزمان
وقال : أتذكُر منذ ثلاثين عاماً…؟
وأذكر كنتُ أمدُّ يدي في بياض النهار
وأنتشلُ القلب من قطّة تتسلى
بما يترك الزائرون على الباب : أسرى وقتلى
فقلتُ : ومملكةُ الله أحلى.
وقال : أفكَّرت بالانتحار كأبناءِ جيلك؟
قلتُ: وكنتُ كأبناء جيلي أُحبُّ فتاةً من الموجِ
كان المساء جريحاً بلا سببٍ واضحٍ تحت شرفتها الواعدهْ
وقفتُ وناديتُ 0 كان الصدى حجراً
فذهبت إلى شاطئ البحر . ناديتُ . كان الصدى قمراً
فجلستُ على صخرةً في المياهِ
وأعددت موتي
فشاهدت وجهي في الماء ,
لكنهم أوقفوني في اللحظة الساجدهْ
وفي سجن عكّا القديم تعلَّمتُ كيف تصيرُ النساءُ وطنْ
وأين الفتاة إذنْ !
فوق شرفتها
تحبُّ الأغاني وتنسى المغنِّي
وتعزل موجتها العائدهْ
….ويقفزُ فوق بلاطِ الشوارعِ
مثل طيورٍ مُبَلِّلة بالزوابعِ
والبرقِ,
يرمي لنا ذكريات عن الشرق :
أُمي تحبُّ دمشق
أبي يتمنَّى الرجوع إلى حجرٍ نام في صدرِهِ
وأُختي تظنُّ العراق بعيداً
وتحسب أن السواد ليالي
فأخبرتُها أنه شجرٌ في الغروبِ
ونؤمن أن دمي يكسر السيفَ… والقاعدهْ
أمِنْ جبلٍ حوَّلْتهُ الليالي إلى قُبَلٍ
أنا ؟
هل تمدَّدتَ تحت الصنوبر؟
خمسةَ عشرَ شتاءً
وبلّلكَ الماءُ؟
بلّلني فذهبتُ إلى الراهبِ الأرثوذكسيّ صلّى أمامي وصلّى لأجلي
وكان جنودُ المظلاّت ظلّي
فلم يستطيعوا دخول الكنيسةِ..
آهٍ على جبلٍ يتشعَّب في جسدي كالشعيرات ’ مليونُ رَحْمٍ يُصلِّي لميلادنا
يا صديقي
ولا تَلِدُ الوالدة
أكنتَ تغنّي كثيراً لها ؟
من هي؟
سَمِّها ما تشاءُ: النساءَ ’ المرايا ’ الكلام , البلاد ’ اتحادَ العصافير في القمح ’ الخلايا , وأوَّلَ موجٍ تَشَرَّد في البرُِ
….مستسلماً للتداعي رأى قلبهُ حَبَّةً من عنبْ
رأى قلبه غيمةً فوق حقل الذهبْ
وتابع غَسْلَ الحقول من الحشراتِ الصغيرةِ , ثم تساءل : كيف يصير المغنّون أُغنيةً عندما يعرفون النساءَ وينسون؟
كُنَّا نغنَّي معاً للغموض الذي
لَفّنا : في الممرِّ الصغير تنامينَ وحدَكِ بين ذراعيك وحدكِ عُشَّاقُكِ اقتربوا
من خناجرهم في الممر الصغير تنامين وحدكِ يلتمس البحر وُدَّكِ ينكسر
البحر عندكِ عُشَّاقُكِ ابتعدوا عن خناجرهم آهِ أيتها المرأةُ الحاملُ المرأةُ
القاتلُ الأرض أصغرُ من صمتك المتواصِلِ لكنَّ بطنكِ أصغرُ
من طعنةٍ أو نشيدٍ سننشدُهُ في الممرِّ الصغيرِ تنامين وَحدَكِ بيني وبينك وَحدكِ بين ذراعيكِ وحدكِ عشاقُكِ اقتربوا من خناجرهم آهِ أيتها المرأةُ الخالدهْ
تُرى , هل يحقُّ لمثلك أن يتأمَّل لوحهْ؟
وأن يتساءل عن مصدر اللهِ
أو يجد الفَرْقَ بين الحمام ومنديل أُمٍّ تودٍّعُ؟
هل نستطيع التجوُّل في السان جرمَان كالغرباءِ الذين يشمون أرض فرنسا
من الجوِّ؟
هل نستطيع الذهاب إلى البرجِ واللُّوْفْرِ؟
هل نستطيع مشاهدة المسرحية دون تقمص أبطالها المتعبين؟
لماذا نكون كما لا نكون ؟
ألم تجد امرأة واحده
تمشط شعرك هذا الصباح
فترتاح للتعب الوثني
فلا يقتلونكَ حين تمرُّ
بلا حارسٍ أو لُغهْ
ألم تجدِ امرأةً واحدهْ
تُطيلُ الصباحَ علي الجسر؟
قد يتعبون من الانتظار
وقد يذهبون إلي نزهةٍ في حدائق فينسانْ
وقد يخجلون من الكلمات التي ستقول لها عن رحيلٍ بلا فائدهْ.
. . . يعرفُ أن الجنود يعودونَ
يعرفُ أن الحشائش سيِّدةُ الأرضِ
لكنه يعبر النهر من أجل أن يعبر النهر
هل تعرف الضفَّةَ المشتهاةْ؟
تماماً كما أعرفُ القلبَ أو أجهُلهْ
ولكنني سأطيعُ خطىّ بدأتَ
وأحمل قلبي إلي جَرَسٍ يشتهيهِ
أطيع خطايَ وأحمل قلبي إلي حَرسٍ يشتهيهِ
على خطوةٍ صاعدهْ.
….يرى موتَهُ واقفاً بيننا فيدخِّنُ كي يُبعدَ الموتَ عنا قليلاً.
يُصفِّر لحناً سريعاً ويطردُ عن معطفي نحلةً ’ ويتابعُ : في شهر تموزَ تذهبُ باريسُ نحو الجنوب , وقد يذهبُ القتلَهْ.
يرى موتَهُ في النبيذِ فيهتف : سيدتي غيِّري قَدَحي . ويتابعُ : كانوا ورائيَ في معرض المُلْصَقاتِ فأسندتُ نافذةً واستدرتُ وصافحتُهم واحداً واحداً….
يلعبُ الموتَ’ يألفُهُ ’ ويباريه . يعرفهُ جيداً ويعرفُ كلّ مزاياهُ ’ يشرح أنواعه: طلقةٌ في الجبين فأسقط كالنسر فوق السفوحِ ،
وقنبلةٌ تحت سيّارتي فتطيُر ذراعٌ إلى الشرفاتِ وتكسر آنية الزهر أو شاشة
التلفزيونِ ,
قنبلةٌ تحت طاولةٍ أو رصاصٌ على الظهرِ أو طلقةٌ تحت حنجرتي هكذا الموت ’ أبسطُ مما تظنُّ
أيوجعُ؟
حين يكون الفتى خائفا
هل تخافُ
إذا جاءني زاحفا
وبطيئاً , فقد أعرف القاتلا
وقد أعرف الطلقةَ الوافدهْ
….على بابِ مكتبهِ شجرُ الكستناءِ
ومقهى صغيرٌ
وقوسُ حمامْ
يرى طالباً عربياً فيرمي عليه السلامْ
يَرُدُّ بطيئاً
ويشرب قهوتَهُ
يصعدُ السُّلَّمَ الحجريَّ
سريعاً كعادته مثل طيرٍ يُبَلِّلهُ البرقُ
يدخل غرفتهُ. يتأمِّلُ أوراقه والخريطةَ والشهداءَ الكثيرين
فوق الجدارِ ويقرأ برقيَّة من دمشق : ((تعالَى مع الصيفِ يا ابني))،
وبرقَّيةً من بقيَّة بيروت: ((شدِّدْ عليك الحراسة))
لم يتساءلْ لماذا يريدون أن يقتلوه
ولم يتذكر بلاداً تنام على صُرَّة الله مثل المسدّسِ,
لكنهم أخبروهْ
أن صاحبَهُ الطالبَ العربي يريد مقابلة عاجلَهْ
فألقى عليه تحيَّتهُ الشاردهْ
وردَّ بأقصرَ منها … وبالطلقةِ القاتَلَهْ
وعاد إلى شجرِ الكستناءِ
ليشربَ قهوته الباردَهْ
- Advertisement -