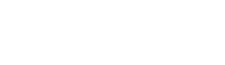كحادثة غامضة

في دار پابلو نيرودا، على شاطئ
الـپـاسفيك، تذكَّرْتُ يانيس ريتسوس.
كانت أَثينا ترحَّبُ بالقادمين من البحر،
في مَسْرحٍ دائريٍّ مُضاءٍ بصرخة ريتسوس:
((آهِ فلسطينُ،
يا اُسْمَ الترابِ،
ويا اُسْمَ السماءِ،
سَتَنْتَصِرين…))
وعانَقَني، ثُمَّ قَدَّمني شاهراً شارةَ النصرِ:
((هذا أَخي)).
فَشَعَرْتُ بأنني انتصرتُ، وأَني انكسرتُ
كقطعة ماسٍ، فلم يَبْقَ منِّي سوى الضوءِ/
في مطعم دافئٍ, نتبادلُ بَعْضَ الحنين
إلى بَلَدَيْنا القديمين، والذكرياتِ عن
الغد: كانت أَثينا القديمةُ أَجملَ.
أَما يَبُوسُ، فلن تتحمَّل أكثر. فالجنرال
اُستعار قناعَ النبيّ ليبكي ويسرِق
دمعَ الضحايا: “عزيزي العَدُوَّ!
قَتَلْتُكَ من دون قصدٍ، عدوِّي العزيزَ،
لأنَّكَ أزعجتَ دبَّابتي” /
قال ريتسوس: لكنَّ اسبارطةَ انكسرَتْ
في مهبِّ الخيال الأثينيِّ. إنَّ الحقيقةَ
والحق صنوان ينتصران معاً. يا أَخي
في القصيدة! للشعر جسْرٌ على
أمسِ والغد. قد يلتقي باعةُ السَّمَكِ
المُتْعَبون مع الخارجين من الميثولوجيا.
وقد يشربون النبيذ معاً.
قلتُ: ما الشعْرُ؟… ما الشِعْرُ في
آخر الأمر؟
قال: هو الحَدَثُ الغامضُ، الشعرُ
يا صاحبي هو ذاك الحنينُ الذي لا
يُفسَّرُ، إذ يجعلُ الشيءَ طيفاً، وإذْ
يجعلُ الطَّيْفَ شيئاً. ولكنه قد يُفَسِرُ
حاجَتَنا لاقتسامِ الجمال العُمُوميِّ…/
لا بحر في بيته في أَثينا القديمةِ،
حيث الإلهاتُ كنّ يُدِرْنَ شؤون الحياة
مع الَبشَر الطيِّبين , وحيث إلكترا الفتاةُ
تناجي إلكترا العجوزَ وتسألها: هل
أَنا أنت حقّاً؟
ولا لَيْلَ في بيته الضيِّق المُتَقَشِّفِ
فوق سطوح تطلُّ على الغابة المعدنيَّةِ.
لَوْحَاتُهُ كالقصائد مائيَّةٌ، وعلى أرض
صالونه كُتُبٌ رُصِفَتْ كالحصى المُنْتَقَى.
قال لي: عندما يحرُنُ الشعرُ أَرسمُ
فوق الحجارةِ بَعْضَ الفخاخ لصَيْدِ القَطَا.
قُلْتُ: من أَين يأتي إلى صوتك
البحرُ، والبحر منشغلٌ عنك يا صاحبي؟
قال: من جهة الذكريات، وإن
كنت “لا أتذكر أَنَيَ كُنْتُ صغيراً”
وُلدت ولي أخَوانِ عَدُوِّانِ:
سجني ودائي.
وأَين وَجَدْتَ الطُّفُولَةَ؟
في داخلي العاطفيّ. أَنا الطفلُ
والشيخُ. طفلي يُعَلِّمُ شيخي المجازَ.
وشيخي يُعلِّمُ طفلي التأمُّل في خارجي.
خارجي داخلي
كُلَّما ضاق سجني تَوزَّعْتُ في الكُلِّ،
واتَّسَعَتْ لغتي مثل لُؤْلُؤةٍ كُلِّما عَسْعَسَ
الليل ضاءتْ/
وقلت: تعلَّمتُ منك الكثير. تعلَّمت
كيف أدرِّبُ نفسي على الانشغال بحبِّ
الحياة، وكيف أُجدِّفُ في الأبيض
المتوسِّط بحثاً عن الدرب والبيت أو
عن ثُنَائيَّة الدربِ والبيتِ/
لم يَكْتَرِثْ للتحيَّة. قدَّم لي قهوةً.
ثم قال: سيرجعُ أوديسُكُمْ سالماً،
سوف يَرْجِعُ…/
في دار پابلو نيرودا، على شاطئ
الـپـاسفيك، تذكَّرْتُ يانيس ريتسوس
في بيته. كان في ذلك الوقت يدخُلُ
إحدى أساطيرِهِ، ويقول لإحدى الإلهاتِ:
إنْ كان لا بُدَّ من رحلةٍ، فلتَكُنْ
رحلَةً أبديّةْ!
- Advertisement -