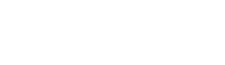المعلم

هي سبّورةٌ
عرضُها العمرُ
تمتدُّ دوني..
وصفٌّ صغيرٌ
بمدرسةٍ عندَ (باب المعظّمِ)
والوقتُ..
بين الصباحِ
وبين الضّحى
لَكَأنّ المعلمَ يأتي إلى الصفِّ
محتمياً، خلفَ نظارتيْهِ،
ويكتبُ فوقَ طفولتِنا بالطباشيرِ،
بيتاً من الشعرِ:
من يقرأُ البيت؟
قلتُ:
ـ أنا..
واعترتْني، من الزهوِ،
في نبرتي رعْدةٌ
ونهضتُ..
على مَهَلٍ
قالَ لي:
تهجّأْ على مَهَلٍ..
إنها كِلْمةٌ…
ليسَ يُخطِئُها القلبُ
يا ولدي..
ففتحتُ فمِي..
وتنفسّتُ..
ثم تهجّأتُها، دفعةً واحدةْ
وطني
وأجابَ الصّدى:
(وطني.. وطني)
فمِن أينَ تأتي القصيدةُ
والوزنُ مختلِفٌ
والزمانُ، قديمْ؟
كان صوتُ المعلمِ، يسبِقُنا:
وطني لو شُغِلتُ..
ونحن نردّدُ:
بالخلدِ عنْهُ
فيصغي إلينا
ويمسحُ دمعتَهُ، بارتباكٍ
فنضحكُ
الله..
يبكي.. ونضحكُ
حتى يضيقَ بنا.. فيهمسُ
ما بالكم تضحكون
أيها الأشقياءُ الصّغار
سيأتي زمانٌ..
وأُشغَلُ عنه
وأنتم ستبكونَ..
وزنانِ مختلفانِ..
وقلبٌ،
تقاسمَهُ جدولانْ
جدولُ الضربِ.. والحبِّ،
ماتَ المعلّمُ،
منذ سنين،
وسرتُ وراءَ جنازتِهِ..
وكان معي،
( وطنٌ لو شُغِلتُ )
وكان يراقبني الناسُ
( بالخلدِ عنهُ.. )
ومرّتْ سنونٌ..
ولم يبقَ في الصفِّ
غيرَ الغلامِ الذي كنتُهُ
بين عشرين، في الأولِ المتوسّطِ..
قال المعلم:
من يقرأُ البيتَ؟
قلتُ:
أنا اقرأُ البيتَ، يا سيّدي
ونهضتُ..
ولكنّني،
لفرْطِ المحبّةِ، أخطأتُ في النّحوِ..
فاسودّ لونُ الطباشيرِ،
واحمرّ لونُ المعلّمِ،
وامتلأَتْ وجنتايَ
بحبّ الشباب..
المحبّةٌ دَيْنٌ..
فيا سيّدي:
أعطِنا ندماً
بقدرِ محبتِنا
وخذْ قلمَ الفحمِ
وارسمْ لنا شاربيْنِ،
وزوّرْ رجولَتنا..
وقدْنا معاً،
لمظاهرةٍ، عند بابِ المعظّمِ
نحملْ وراءكَ سبّورةً من قماشٍ قديمٍ
وبيتاً من الشعرِ
لا يُخطِئُ القلبُ فيه..
…………………..
خرجنا من الصفِّ
كانتْ براءَتُنا،
مُخبّأةً في كتابِ الحسابِ
وحين وصلنا إلى البابِ
راح المعلّمُ يسبقنا،
أشعثَ الشعرِ
يلهثُ منْ غَيْرةٍ
ونحنُ،
وراءَ لهاثِ المعلّمِ
نبكي ونضحكُ
مختلطِينَ
بصوتِ الهتافاتِ والطلقاتِ
فمِنْ أينَ تأتي القصيدةُ،
والمخبرونَ،
يسدّونَ كلّ الشوارعِ
أوقفني عندَ ” عقدِ النّصارى ” المحقّقُ
كنتُ أقولُ لهُ:
وطني..
فيشتمُني
فأصرخُ
بالخلدِ عنهُ..
ويضربُني
فأهتفُ
بالسّجنِ
صاحَ:
خذوهُ إلى السجنِ
فاقتادني المخبرونَ
وعن كثبٍ
كان شعرُ المعلّمِ،
يبيضّ من ألَمٍ..
وصوتُ التلاميذِ
يشحُبُ،
بين الصّباحِ
وبين الضّحى..
…………….
خرجتُ من السّجنِ..
متّسِخاً..
مثلَ سبّورةٍ،
كتبَ السجناءُ عليها شتائِمَهمْ..
كنتُ ممتلئاً بالعناوينِ،
أحملُ تاريخَ كلِّ المساجينِ،
في بيتِ شعرٍ،
سيبقى يلاحِقُني..
( وطني لو شُغِلتُ بالخلدِ عنهُ
نازعتْنِي إليهِ……………… )
عراقيّةٌ
تتقِنُ الموتَ والحبَّ..
وزْنانِ مختلِفانِ
وعينانِ واسعتانِ
وحِجْلٌ ثقيلُ..
وكحْلٌ
وأسئلةٌ
وفضولُ..
ذهبنا إلى الكاتبِ العدلِ،
والكاتِبُ العدلُ
أرسلَ أوراقَنا للمحقّقِ،
قالَ المحقّقُ،
وهو يُحدِّقُ
ما بين عينيّ:
والآنْ..
من يقرأُ البيت؟
صاحتْ:
أنا أقرأُ البيتَ..
والتَمَعَتْ،
مثلَ ياقوتةٍ،
تحتَ شمسِ ضَرَاوَتِها..
وخُيّلَ لي،
أنّ هذا المحقّقَ
يمضي بها، إلى غرفةٍ
على شارعِ النهرِ
وهي تقولُ له:
وطني..
فيشتمُها..
فتصرُخُ غاضبَةً
لو شُغلتُ..
فيبصقُ في وجهِها
فتهْتِفُ:
بالخلْدِ عنهُ..
فيضرِبُها..
فتصيحُ،
وقدْ أوجَعتْها كرامتُها:
نازعتْنِي إليْه..
في الموتِ..
……………………
كانتْ عراقيّةً..
وكانتْ، إذا أقبلَ الحبُّ
أوْ أقبلَ الموتُ
ينتابُها شغَفٌ
مثلَ قِدِّيسَةٍ..
فتُطفئُ شمعتَها.. وتموتْ.
……………………….
سُكُوتْ..
لمْ يعُدْ ثَمَّ،
مَنْ يتجرّأُ..
أنْ يتهجّأَ بيتاً مَن الشعرِ
أوْ يتذكّرُ،
في السّرِّ،
عنوانَ بيتِ حبيبتِهِ..
فالمعلمُ ماتْ
ولمْ يبقَ،
غيرُ غبارِ الطباشيرِ
والكلماتْ..
فكيفَ، تتِمُّ القصيدةُ؟
إنّي لفرْطِ المحبّةِ، والحزنِ
أخطأْتُ في الوزنِ،
فانقطّعَ البثُّ..
………………………….
………………………….
ثمّ ابتدا البثُّ..
قالَ المذيعُ:
إذاعةُ بغدادَ
طِبْتمْ صباحاً
فطِبْنا.. وطابَ الصباحُ..
وأحسَسْتُ
أنّ شذىً،
يتصاعدُ منْ رحِمِ الأرضِ..
فيه مزاجٌ من الماءِ والطينِ،
والقمحِ،
قبلَ اختمارِ العجينِ..
وخُيّلَ لي،
أنّها شاشةٌ، عرْضُها العمرُ،
تمْتدُّ دوني..
لكأنّي بذاك المعلمِ،
يظهرُ، متّقداً بالحنينِ
ويقراُ للناسِ بيتاً من الشعرِ..
قالَ المُعلّمُ:
من يحرسُ البيتَ؟
قلتُ لهُ:
أنتَ مَنْ يحرسُ البيتَ يا سيدي..
واعترتْني من الزّهوِ،
في نبرتْي رعْدةٌ..
فأفَقْتُ..
رأيتُ شموعاً،
ببابِ المُعَظّمِ مُوقَدَةً،
وهلالاً يسيرُ على الماءِ،
يتْبعُهُ موْكبانِ،
من الحبّ والكبريَاءِ..
فأينَ خِتامُ القصيدةِ؟
إنّ المعلمَ يسبِقُنا..
ونحنُ وراءَ المعلمِ،
نلهثُ..
كنتُ أقولُ لهُ:
وطني..
فيعانقُني..
وأهمسُ مضطرباً:
لو شُغِلتُ..
فيسألُني:
بماذا شُغِلتَ..
ويُومِي، إلى موكبِ الشّهَداءِ..
لكَ الله يا سيّدي..
لكَ اللهُ يا سيّدَ الشعراءِ..
أنا غيْرتي نازعَتْني..
وعَيّرَني،
لحظةَ الشعْرِ صَمْتي..
( رأيتُ المواكبَ تزحفُ دوني..
صرختُ خذوني..
فلمْ يسْمَعِ الرّكبُ،
صوتي..
تعرّقَ للحربِ قلبي
كما الأمُّ عندَ المخاضِ،
وقدْ سَجَرَ الناسُ للخبزِ،
قلتُ:
العوافي لكمْ
كلّ ما تسجُرُونَ
وصُبُّوا على النارِ زيتِي.. ).*
أنا رجلٌ ما يزالُ يُجرّبُ
أنْ يمزجَ الماءَ بالزّيتِ
والزيتَ بالدمِ..
والدّمَ بالدّمعِ..
ملتبسٌ
أبداً
بين وجهينِ
وجهٍ بريءٍ..
ووجهٍ مرائي.
ذهبتُ إلى الكاتبِ العدلِ،
والكاتبُ العدلُ
أرسلني للمحقّقِ..
قلتُ لهُ
ما ترى؟
إنّهُ آخرُ العمرِ،
ما عادَ متّسعٌ،
لأُتِمَّ القصيدةَ..
خذني إلى الحربِ
يا سيّدِي..
لعلّي هنالِكَ،
أختمُها بدمائي..
23/11/1985
- Advertisement -